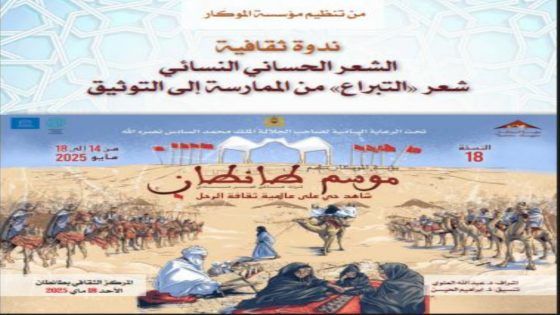كتاب “فنون وعادات البيضان”كتاب يقع في 480 صفحة، وترجمه الباحث المغربي، أحمد البشير ضماني، وأصدره مركز الدراسات الصحراوية، ويتناول الجزء الغربي من إفريقيا، الذي كان يقطنه أو يجوبه “البيضان” بربراً كانوا أو عرباً،وهو الترجمة العربية لمؤلف مرجعي حول الثقافة الحسانية لكاتبته أوديت دي بويغودو.
ويضع هذا العمل المتميز بين أيدي القارئ مجموعة من المقالات حول عالم البيضان تم نشرها ما بين 1968 و1980 في مجلة هسبيريس تامودا، الصادرة عن كلية الآداب بالرباط. وتتناول هذه المقالات طبائع البيضان وعاداتهم وحياتهم الأسرية وملابسهم وحياتهم الثقافية وصناعتهم التقليدية، وتشمل أيضا معطيات عن المدن القديمة الرئيسية في هذا المجال الجغرافي، الذي يمتد من الأطلس الصغير إلى نهر السنغال ومن غرب مالي إلى المحيط الأطلنتي.
الكتاب، الذي تمت ترجمته للعربية– حسب باحثين – من أهم المراجع حول “الثقافة الحسانية” (قبائل بني حسان)، ويضم رسومات لم يسبق نشرها لأعمال من الجلد والخشب والمعادن والأدوات والألعاب.
ومن خلال هذه النصوص والرسومات والنقوش، يسمح الكتاب باكتشاف الإرث العلمي لأوديت دو بويغودو، وهي صديقة كبيرة ومخلصة للمغرب. ولدت في عام 1894 في سان نازير بمنطقة بروتاني بفرنسا وتوفيت في الرباط سنة 1991.وعاشت بالمغرب بين عامي 1939 و1960، متنقلة بين وظائف عديدة في الإذاعة المغربية، ووزارة الإعلام والمتحف الأثري في الرباط.، جالت أوديت دو بويغودو العالم الصحراوي الحساني ما بين 1933 و1960 وناضلت من أجل الحفاظ على غناه التراثي والإنساني.
ويشكل هذا الكتاب مساهمة مهمة في التعريف، على المستويين الوطني والدولي، بأحد المكونات الأساسية للثقافة المغربية المتعددة، مكون يشكل تراثا ثمينا نتقاسمه بشكل خاص مع أشقائنا الموريتانيين.
كان الكتاب في الأصل مشروع أطروحة جامعية شرعت الباحثة الأنثوبولوجية المذكورة فيها سنة 1958 تحت إشراف ثيودور مونو. وكان يحذو أوديت دو بويغودو أمل في أن تكون مفيدة يوما ما للصحراويين أنفسهم، الذين استضافوها وساعدوها وحموها وأرشدوها، عندما يحين الوقت الذي سوف يبحثون فيه في بطون الكتب عما كان مألوفا لديهم بالأمس القريب. غير أن أبواب جامعة «السوربون» ظلت موصدة في وجهها، فلجأت إلى نشرها في مجلة «هيسبريس تامودا»، ولم تطبع مجتمعة في كتاب واحد إلا بعد مرور أزيد من عقدين.
حظي كتاب «فنون وعادات البيضان: الترغيب في الصحراء» تدريجيا، ومع مرور الزمن، باهتمام علمي من طرف المهتمين عموما بتطور مجتمع البيضان، فصدر كاملا لأول مرة عن منشورات إيبيس برس في باريس سنة 2002 ، ثم عن منشورات لو فينيك في الدار البيضاء سنة 2009. يشتمل الكتاب على مقدمة وخمسة فصول خصصت على التوالي للمجالات التالية:
_تاريخ وجغرافيا تراب البيضان
_ الحياة المادية (السكن، اللباس، الحلي)
_الحياة الأسرية (الزواج، الأطفال)
_ الحياة الثقافية (التعليم)
_الصناعة التقليدية (عدة ركوب الإبل)
وتتلخص الاستنتاجات التي خرج بها المترجم من هذا المؤلف في ثلاث نقاط:
ـ تراب البيضان هو، جغرافيا وبشريا، تراب واحد، وهذه الوحدة مسألة جدية لا بد من أخذها بعين الاعتبار عند مقاربته بهدف دراسته والسعي إلى فهمه ووصفه، وأن كل محاولة للنظر إلى الحدود الاستعمارية التعسفية المجزئة له والمفرقة بين ساكنته، مهما كانت أصولها العرقية، على أنها فواصل تعكس اختلافات حقيقية مآلها الفشل وتشويه الحقائق.
ـ تكامل أنماط العيش المختلفة التي كانت سائدة فيه قبل التحولات المعاصرة، فحياة الاستقرار، الذي ظل جزئيا مع كل مظاهره، ليست إلا امتدادا لتقاليد الترحال والرعي.
ـ خلف ثراء فنون وعادات سكانه، تقف موجات الهجرات البشرية المتتالية عبر العصور، والمبادلات المكثفة والتلاقح الثقافي بين ضفتي الصحراء، والروابط الحضارية والتاريخية التي ظلت تجمعه، على الدوام، بالمغرب والمشرق، فالصحراء لم تشكل في تاريخها الطويل والعريق حاجزا طبيعيا أبدا، كما تدعي ذلك الأيديولوجيا الاستعمارية، بقدر ما كانت، ومنذ أقدم العصور، صلة وصل وعامل تواصلٍ ومثاقفةٍ ومعبرًا لتبادل المنتجات والخبرات والأفكار والمعتقدات بين شمال إفريقيا وبلدانها السوداء.
تبقى الإشارة إلى أن مترجم الكتاب أحمد البشير ضمـــــاني باحث في تاريخ وتراث المناطق الصحـــــراوية وعضــــو اتحاد كتاب المغرب، صـــدر له كتاب «الشاي في المغرب الصحراوي من الغرابة إلى الأصــــالة» و«الـشـــاي الصحراوي: درس التاريخ وسياقات التغـــير الاجتماعي»، وقام بتعريــــب كتاب تحت عنوان «المغرب الصحراوي: تراث ماء ونخـــيل وخـــبرة بشـــرية»، وأيضا كتاب «الملحفة: زي نساء المغرب الصحراوي»، علاوة على عدة بحوث ودراسات ونصوص مترجمة صدرت في مجلة «ثقافة الصحراء» ومجلة اتحاد كتاب المغرب «آفاق».
لا يتعلق الكتاب بمؤلف في التاريخ أو الجغرافيا أو العلوم الطبيعية أو اللسانيات، فقد سعت مؤلفته أوديت (1894-1991) إلى رسم صورة مادية ومعنوية للبيضان، ووصف طبائعهم وعاداتهم، وجرد الأشياء الضرورية لوجودهم.
أصالة البيضان:
في وصفها لـ”البيضان” تشير الكاتبة إلى أنه غالباً ما يقارنون في عاداتهم الشرقية وثيابهم الفضفاضة الواسعة وقطعانهم وخيامهم السوداء برعاة زمن النبي إبراهيم عليه السلام،
إلا أن أصالة البيضان، حسب الكاتبة، “تتمثل بالضبط في تقديمهم لنا، وبطريقة حية للغاية، صورة تلك المجتمعات الغابرة، وفي حفاظهم على تقاليد وعادات وفنون قديمة كتراث غير قابل للتعويض”.
في تلك المناطق يعرف البيضان كيف يحافظون على أصالتهم من خلال “البقاء على اتصال من أعماق البيداء التي أجبرتهم على شظف العيش، ولكنها حمت حيويتهم وكيان روحهم بالمراكز الدينية والثقافية والاقتصادية.. لقد كانوا يعودون من خلال أداء فريضة الحج إلى منابعهم، مستمرين كذلك في البقاء على المستوى الروحي”.
ولقد عرف هذا المجتمع الصحراوي القديم والأصيل المختلف عن المجتمعات المحيطة به كيف يتكيّف بذكاء وشجاعة مع قساوة الصحراء.
وحسب وصف الكاتبة، فقد أحيا البيضان الصحراء، واستخدموا مواردها ببراعة عنيدة، ووجدوا فيها القدر ذاته من القوة والسعادة، الذي لقيته شعوب أخرى بعيدا في أراضٍ أكثر ثراء.
وعلاوة على ذلك فإن “كبرياء البيضان الاستثنائي، ونفورهم الفطري من تقبل الأشياء الأجنبية الجديدة بينهم، جعلهم يحافظون في وعاء الصحراء المغلق، وببالغ الحيوية، على أشكال فنية موغلة في القدم، رموز، زينة غريبة، ودقيقة وساحرة، نسي الصنّاع الذين يخططونها أو ينحتونها بكل دقة ومنذ زمن طويل مصادرها البعيدة”.
ورغم أن البيضان يترددون في السماح بإحصائهم؛ إلا أن الكاتبة تشير إلى أنه من الممكن تقدير مجموع سكان أرض البيضان خلال تلك الفترة بحوالي مليون نسمة.
نساء البيضان تميزت المجتمعات الصحراوية بالمكانة المميزة للمرأة، التي تبدو مختلفة عن المناطق الأخرى، سواء من حيث الشكل أو المكانة.
وتتوقف الكاتبة لوصف المرأة البيضانية، التي يبدو أن أول ما يثير فيها هو امتلاء جسمها المقصود، فلقد “ظل الامتلاء المفضل من قبل في القرنين الـ11 والـ16 أحد معايير الجمال لدى البيضان. إنه يحظى بالتقدير إلى الحد الذي يجعل النساء يبذلن في سبيل نيله التضحيات الجسام”.
إلا أن هذا الامتلاء لا يتراءى إلا من وراء الإزار، الذي يخفي البدانة الزائدة، “فلا يُرى من البيضانية سوى قسمات الوجه الجميلة، وعينين رائعتين تلمعان في ظل أهداب طويلة، ومقدمة إكليل من الشعر الحريري، حيث علقت فوق الجبهة تميمة من الفضة”.
وفيما يتعلق بالزواج، فقد حافظ البيضان على العادات البربرية العريقة والمختلفة عن تقاليد إفريقيا الشمالية، فهم يشكلون – حسب الكاتبة – “مجتمعاً أمومياً أحادي الزواج، بما لا يتناقض مع الأحكام الأساسية في الشريعة الإسلامية”.
لكن ما يثير انتباه الكاتبة هو الزواج المبكر للبنات في المجتمع الصحراوي، حيث إنه “لا الشريعة الاسلامية ولا الأعراف ولا المصلحة الحيوية للقبيلة تقبل العزوبة ولا مكان في الصحراء للمرأة العازبة”.
التعليم والتربية
أقصر الطرق إلى الله في نظر أهل الصحراء هو “إعطاء الصدقة وتعلم العلم وتعليمه”.
هكذا تشيد الكاتبة بالأهمية الكبيرة التي يحظى بها تعليم الأطفال منذ سنواتهم المبكرة، حيث يؤمن البيضان أن التعليم يقوم أساساً على الصدقات، بل إنه هو نفسه صدقة العالم على الجاهل وفريضة دينية.
“المَـحْضرَة” هو المصطلح المعتاد الذي يشير إلى مدرسة الرحل بصفة عامة، بغض النظر عن درجتها أو نوعها إن كانت مدرسة قرآنية أم معهداً للتعليم الثانوي، أما التلميذ فيسمى- صغيرا كان أو طالبا- “محضريا”.
وحسب الباحثة، فإنه عادة ما يقوم زعيم المخيم، في حال كان لديه أطفال في سن المدرسة، بالتكفل بإعالة المعلم، ويوفر له مطية أثناء أسفاره، لكن هذا لا يمنع آباء باقي التلاميذ من تقديم الهدايا المعتادة.
ولا يقتصر التعليم على طبقة دون أخرى عند البيضان، وإنما “هو عمل إحساني، ومن نافلة القول أن الأطفال الفقراء يتلقون التعليم نفسه، الذي يتلقاه أبناء من تمكنهم مواردهم من البذل بسخاء”.
تحولات المجتمع
مقابل الأصالة التي ميزت تلك المجتمعات الصحراوية لأزمنة طويلة، ترصد الكاتبة تحولات في عادات البيضان قائلة “في كل رحلة من رحلاتي بين سنتي 1934 و1960 كنت أجد بعض التحولات التي سرّعت من الصدمات الارتدادية للحرب العالمية والعوز، وتشكل طبقة دنيا من طراز استعماري”.
وتتمثل العلامات الواضحة لتلك التحولات “في الخيام الكاكية (لون بني مصفر) وعدة رواحل خيطية في مخيمات أنهكها الفقر، الثياب الأوروبية الرثة، الألبسة المستعملة ذات الألوان الفاقعة التي تكسر الانسجام الداكن للملاحف (الملاءات)، الحلي البلاستيكية، أباريق الشاي أو أطباقه الصفيحية”.
وتضيف “باتت الحفلات الغنائية الليلية الرائعة نادرة، وحلت محلها الأسطوانات والمذياع، ولجأ الموسيقيون، الذين لم تعد القبائل المفلسة قادرة على احتضانهم، إلى مدن المغرب والسنغال، حيث سريعاً ما فقد فنهم بريقه”.
ويبدو المخيم البيضاني لعيني المسافر كما يصفه الكتاب شبيهاً بـ”قرية صغيرة أسطحها مخروطية تتجمع في مأمن من الصخور وفي تجويف واد بين شجيرات هزيلة، أو على جانب بضعة كثبان تتيح للناظر رصد ما حولها..على أي حال يود البيضاني احترازاً منه أو عن ذوق أو عادة، أن يَرَى دون أن يُرى”.
ويخصص النهار في مخيم البيضان للقيام بشؤون الحياة اليومية المادية؛ أما المساء فمن أجل التواصل والحكايات، حيث “توقد النيران مساءً أمام الخيام، فيتجمع حولها الناس في سهرات طويلة لمناقشة شؤونهم الجماعية، وسماع روايات المسنين والقصائد المرتجلة من طرف الشعراء”.
أما في الأعياد فيجري تنشيط الساحة الكبرى في القرية أمام مضرب الزعيم أو خيمة الضيوف، بالرقصات والأغاني على إيقاع الطبل وألعاب اليافعين والرعاة.